اختلف القرآن الكريم عن بقية الكتب السماوية بأنه جمع بين المعجزة والمنهاج، أما الكتب السماوية الأخرى والتي نزلت قبل القران كانت تحمل المنهاج أما المعجزة، فهي ما أجراه الله تعالى على يد أنبيائه، فمعجزة نبي الله موسى عليه السلام كانت العصا التي تحولت إلى حية، وشق بها البحر فكان طريقًا يبسا، لكن كتابه الذي تضمن منهاجه، هو التوراة، ومعجزة، نبي الله عيسى عليه السلام إبراء الأكمه، والأبرص، والأعمى، وإحياء الموتى كل ذلك بإذن الله تعالى، أما كتابه، فهو الإنجيل، ولأن الرسالة اليهودية والرسالة النصرانية إنما جاءتا لزمن معين ولقوم معينين، فلم يتكفل الله تعالى بحفظ كتبهم، ولكن أوكل حفظهما إلى قوم كل نبي، فدسوا فيهما ما شاءوا من تحريف وأساطير، وقالوا هذا من عند الله، يقول تعالى: (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) البقرة/ 79.
إن أهل مكة الذي نزل فيهم القرآن، وكان بين أظهرهم، ولمسوه بأيديهم، وعاينوه بأعينهم، ورأوا كثيرا من معجزاته، وكيف تحداهم بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور وكانوا يزعمون أنها مفتراه، ثم تحداهم بأن يأتوا ولو بسورة واحدة، فعجزوا عن ذلك كله، وهم أرباب البلاغة والبيان، وأصحاب المعلقات السبع أو العشر، فثبت عجزهم المطلق، يقول تعالى: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) الإسراء / 88.
ولأنه معجزة تعهد الله تعالى لها بالحفظ، وصانها من أن يدسوا فيه ما ليس منه، قال سبحانه وتعالى: (إنَّا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) الحجر / 9. وقال عنه أيضًا: (..وإنه لكتاب عزيز(41) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد(42) فصلت.
إنه كتاب لا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه مهما تطاول عليها الزمان، وهو عدل مطلق من حكم به عدل، ومن عمل به أُجِرْ، ومن قال به صدق، وهو كتاب لا يشبع منه العلماء.
كتاب معجز جمع الله تعالى فيه المعجزة والمنهاج الذي يرسم فيه معالم الصراط المستقيم، من ألزم نفسه به وبقيمه ومبادئه، وتمسك بأوامره ونواهيه كان من أعلام الصراط، يقول تعالى: (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) النساء / 69.
وحتى يكون هؤلاء جميعهم من الفائزين في الدنيا والآخرة، ومن الذين نسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم، فعليهم أن يأخذوا منهاج الإسلام بقوة، ليعرفهم الناس بمنهاجه ولا يعرف المنهاج بهم، وحين أراد الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن يعرَّف كلا من المسلم والمهاجر، قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» متفق عليه.
الرسول الأعظم (صلى الله عليه. سلم) استدل على حقيقة إسلام المسلم بسلوكه لا بكثرة عباداته، كذلك حين أراد أن يقرب مفهوم المؤمن عند الناس قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفِي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قَدَّر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» رواه مسلم.
ونلاحظ في هذا الحديث أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) لم يذكر من صفات المؤمن التي يعرف بها كثرة الطاعات، بل ذكر صفات يستدل بها على حقيقة المؤمن، فوصفه بالقوة فقال: «المؤمن القوي» ووصفه بالاستعانة به تعالى، ومن صفاته أيضًا حرصه على كل ما ينفعه في الدنيا والآخرة، وعدم العجز، وهذه كلها من الصفات المعنوية التي يعرف بها المؤمن ولا يعرف بضدها، وهذه الصفات يستدل بها على قوة المؤمن، وثبات شخصيته، وبعد أن عَدَّدَ الصفات التي تعرف بها قوة المؤمن من ضعفه ختمها بالصبر على البلاء، وتفويض الأمر إلى الله تعالى، بقوله: «قَدَّرَ الله وما شاء فعل» أي إن قَدَر الله تعالى له خير من قَدَرِه لنفسه !.
ذالكم هو إسلامنا العظيم، وهذا هو كتابه الكريم الذي تعهد الله تعالى بحفظه، ووعد بصيانته من التحريف والتبديل.
إذًا، فهذا هو قرآننا العظيم، كتاب جمع بين المعجزة والمنهاج، وهذا لم يتحقق لكتاب قبله أبدًا.


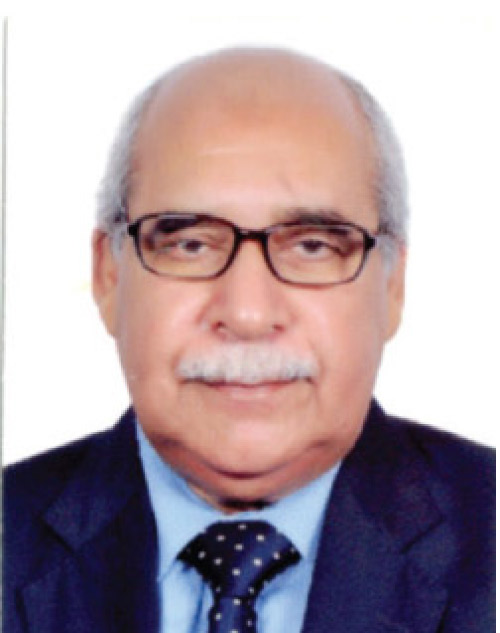






هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك