بعد قرون من التخلف واجهت البشرية تغول الكنيسة ورجالها، مما احتاج الأمر إلى القيامة بثورة تصحيح مما عانت منه البشرية الويلات من خلال سيطرة الكنيسة ورجالها، وكانت هناك حاجة ملحة إلى مثل هذه الانتفاضة التي كفّت أيدي رجال الكنيسة عن التدخل السياسي في شؤون الناس، وهذه الثورة لم تقتصر على سحب السلطة من أيدي رجال الكنيسة، وتحجيم دورهم وقصره على الدعوة إلى إقامة الشعائر الدينية فقط، ولا شأن لهم بالحكم وشؤونه، وكانت العَلْمانية هي الصرخة المدوية التي أطلقها العلماء والمفكرون والسياسيون ليخلصوا البشرية من استبداد رجال الكنيسة، وملوك أوروبا الذين كانوا يستمدون شرعيتهم من الكنيسة ورجالها، ولأن العَلْمانية ليست نظرية شاملة للسلطة وشؤون الحكم، وإنما اقتصر دورها على تخليص الناس من سلطان الكنيسة، وتقديم وجهة نظر سياسية في الحكم مغايرة لما هو سائد من أنظمة الحكم تقوم على مبدأ الديمقراطية، وهي حكم الشعب للشعب وبالشعب، ولأنها – كما أسلفنا – ليست نظرية شاملة للحياة وشؤونها المختلفة، وأنها قد شابها الكثير من القصور ولَم تعد صالحة لمعالجة شتى مناحي الحياة، وخاصة عندما تدخل في سباق مع الإسلام، الدين الكامل، والنعمة التامة، وكان سوء الفهم عند المثقفين والسياسيين لعظمة الإسلام، وشموليته في الآيات المحكمات التي لا سبيل إلى الاجتهاد فيها، وتجاوز أحكامها القطعية الدلالة والثبوت، أما الآيات المتشابهات، فلعلماء المسلمين أن يجتهدوا فيها، ويرفدوا الشريعة الإسلامية بالكثير من الحلول الشرعية التي هي نتاج العقل الإسلامي الراشد. ويروى أن الإمام الشافعي كان يفترض مسائل كثيرة، ثم يعمل عقله في البحث عن حلول لها في القرآن الكريم، والسنة المطهرة، ونستطيع أن نقول إن الشريعة الإسلامية تستوعب جميع شؤون الحياة سواء ما يتعلق بفقه الواقع، أو الفقه المتوقع كما فعل الإمام الشافعي (رضي الله عنه). لقد وقعت العَلْمانية في خطأ كبير، بل نستطيع أن نقول إنها وقعت في خطيئة عظمى حين ظنت أنها قادرة على تقديم حلول شافية لكل ما يواجهه المسلمون من مشاكل العصر، وأن المسلمين يستطيعون أن يستغنوا بالعَلْمانية عن الإسلام، وهذا وهم كبير على المثقفين والسياسيين العرب أن يفيقوا منه إذا أرادوا اللحاق بركب الحضارة، وجني قطوفها الدانية، وثمارها اليانعة، فالإسلام في مجال العقيدة يقدم لنا حقيقة العقيدة الصافية في قوله تعالى: «قل هو الله أحد (1) الله الصمد (2) لم يلد ولَم يولد (3) ولَم يكن له كفوًا أحد (4)» سورة الإخلاص.
وفي الإسلام العقوبة لا تسقط بمضي المدة، بل تلاحق صاحبها حتى يوم البعث، وهذا يعني أن حقوق العباد لا تضيع أبدًا بينما في العَلْمانية قد ينجو بها الطغاة والمستبدون لأن النظم الوضعية تحميهم.
في الإسلام نعم المال الصالح للعبد الصالح، وفيه أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أما في العَلْمانية فليس مهمًّا مصدر المال أحلال أم حرام، المهم أنك إذا استطعت أن تنجو من عدالة الأرض، فلك ما اكتسبته من مال، وإن كان مصدره حراما.
في الإسلام الزنا حرام، والعلاقات المشبوهة بين الرجال والنساء حرام، فتكون بذلك الأنساب مصونة، أما في العّلْمانية فيعتبر الزنا حرية شخصية، والشذوذ بين الرجال والرجال وبين النساء والنساء لا شيء فيهما، بل تعقد الزيجات بين الشواذ في الكنائس، ويباركها رجال الدين في وقت تحرم المسيحية زواج القساوسة.
لقد حسم الإسلام الخلاف في مسألة الحكم ولم يفرض القرآن الكريم نوعًا من الحكم على الناس، لكنه وضع قواعد عامة منها: العدل والشورى، فقال تعالى عن العدل: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا». (النساء/58).
وأشار القرآن العظيم إلى مبدأ الشورى في موضعين مباركين من القرآن الكريم الأول في قوله تعالى: «والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون» (الشورى/38). ولقد أكد الحق سبحانه وتعالى هذا المبدأ العظيم في قوله تعالى: «فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» (آل عمران / 159).
وبعد، فهذا موقف الإسلام والعَلْمانية من بعض القضايا التي تهم المسلمين وتقض مضاجعهم، وعليك أيها الإنسان ولا أقول فقط أيها المسلم، أن تختار، وما ترجح لك في حياة قصيرة مفعمة بالبلاءات، والمصير فيها مؤكد إما إلى جنة عرضها كعرض السموات والأرض، وإما إلى نار لهيبها مؤكد أيضا، فأيهما تختار.!!


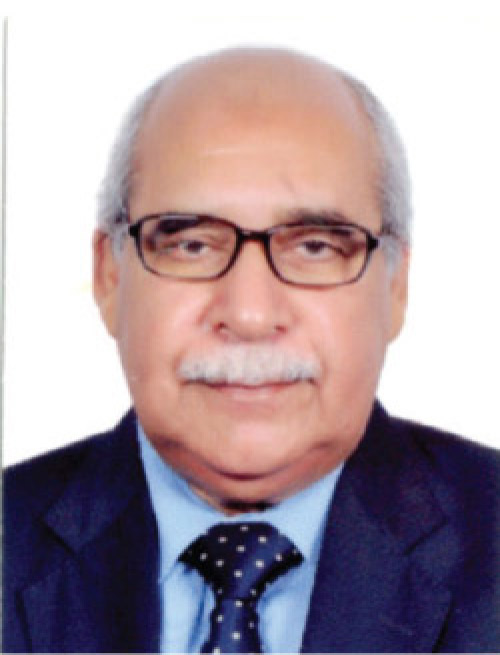






هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك