العربية.. وعاء وسقاء.! ما حقيقة هذا القول أو هذا العنوان؟
العربية وعاء، هذا حق لا شك فيه، فهي أكرم وعاء، وأشرف وسيلة جعلها الله تعالى بينه سبحانه وبين رسوله محمد (صلى الله عليه وسلم)، ولقد بلغت العربية أعلى مراتب الكمال، إذ جعلها مؤهلة بكفاءة عالية على أن تكون وعاءً زاخرًا بالعطاء، وموردًا عذبًا يتدفق منه الخير سلسالًا من دون انقطاع، ولقد يسر الله تعالى الوصول إلى غاياته، فقال تعالى: «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» القمر / 17. لقد جاء تأكيد هذا المعنى في سورة القمر في أربعة مواضع هي الآية: (17 ، 22 ، 32، 40)، وفِي هذا مبالغة في تأكيد يسر القرآن، وسهولة فهم مقاصده إلا ما احتاج إلى زيادة بيان ، ولهذا فالقارئ للقرآن، التالي لآياته وسوره يكاد يعي ما يقرأ، وعلى قَدر استيعابه يكون عطاؤه، فالعربية تميزت عن باقي اللغات بأنها اللغة الوحيدة التي اختارها الله تعالى ليجعلها لغة وحي، وهي لغة محفوظة بحفظ الله تعالى لوحيه المقدس، قال سبحانه وتعالى: «إنَّا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» (سورة الحجر / 9 )، وبما أن الذكر هو الوحي المقدس، وهو آخر اتصال السماء بالأرض، وحفظ هذا الإنزال يقتضي حفظ الوعاء الذي نزلت فيه هذه اللغة، وتكون كرامتها من كرامته، وعزتها من عزته، وخلودها من خلوده، وهو -أي القرآن- شاهد على جلال اللغة وقدرتها على الوفاء بما تحويه من مضامين إلهية.
وكذلك يترتب على كمال وتمام حفظ النص الإلهي حسن الأداء وتدفق العطاء من نبع لا ينضب، ونهر لا يتوقف جريانه.
والسؤال الذي قد يشكل على البعض هو: لماذا اختار الله تعالى اللغة العربية من دون غيرها لتكون الوعاء الذي أنزل به القرآن؟
ونظن أن الجواب على هذا السؤال متعلق بتميز هذه اللغة على باقي اللغات بغناها وشمولها، وأنها بلغت مرتبة الكمال أو قريبًا منه، وأنها بهذا تكون مصدر اللغات العالمية وسيدة هذه اللغات وحق لمن كانت هذه صفاتها أن يختارها الله تعالى لتلقي الوحي عن الله تعالى، ثم تعيد بثه إلى الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، وهي فوق هذا وذاك تتميز بكثرة مترادفاتها، وتعدد مفرداتها حيث تجد للشيء الواحد العديد من الأسماء، فتجد للأسد مثلًا عشرات الأسماء له وهذه الكثرة تعين المبدع من الأدباء على التوسع والمرونة في اختيار اللفظ المناسب فيضعه في المكان المناسب، وهي بهذه الميزة وغيرها كثير تكون أكثر اللغات قدرة وشمولية على شفاء ما في الصدور من أدواء، وإشباع طالبي العلم والباحثين عن الحق لأنها تملك الكثير من الأجوبة الشافية عن كل الأسئلة صعوبة والتباسًا، وسيظل القرآن العظيم ولغته الساحرة مصدرًا من مصادر المعرفة، ونهرًا سلسبيلًا يتدفق نبعه ولا يتوقف جريانه. ولهذا فلا عجب ولا استغراب أبدًا في أن يكون القرآن وحده دليل الحائرين إلى صراط الله المستقيم، وأنه السبيل إلى معرفة الخالق سبحانه حق المعرفة، وعندما يصل العلماء والباحثون إلى معرفة الحق فإنهم سرعان ما يقبلون على الإسلام من دون تردد أو شك أو ريبة، وإذا بهم يصدعون بأن هذا القرآن يستحيل أن يكون قول بشر أيًّا كان علم هذا البشر وقدرته على البيان والإتقان، وبذلك ينتهي طواف هؤلاء العلماء والمفكرين إلى الغاية التي يبحثون عنها وهي معرفة الخالق سبحانه، والإيمان به عن يقين راسخ، ولهذا تراهم يتحولون إلى دعاة إلى هذا الدين يبينون حقائقه للناس من بني جلدتهم، فيكونون أكثر توفيقًا من غيرهم من الذين لم يبلغوا درجتهم في العلم والتوفيق، ولذلك نستطيع أن نقول وبقناعة قد لا يؤمن بها كثير من الناس إن الإسلام يستقبل كل يوم دماءً جديدة تجدد شبابه، وترفد مسيرته المظفرة، إن شاء الله تعالى.
وكما أن القرآن العظيم يستقبل كل يوم دماءً جديدة، فإنه كذلك يستقبل فهومًا جديدة من خلال قراءة النص المقدس، قراءة فيها تدبر يكشف للمسلم معاني جديدة، ويلهمه فهمًا قد غاب عنه في قراءته الأولى، وهذا المعنى تمت الإشارة إليه في قولهم عن القرآن: إنه لا يخلق على كثرة الرد، ولا تنتهي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء.
كما أن القرآن العظيم محفوظ بحفظ الله تعالى له، فهو كذلك محصن من أن تناله أيادي العابثين والمزورين، يقول سبحانه وتعالى: «..وإنه لكتاب عزيز(41) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد(42)» سورة فصلت
ومعلوم أن بقاء القرآن وغلبته، رغم كل محاولات الطعن فيه، إنما هي من أدلة التوحيد بأنه سبحانه واحد لا شريك له، يقول تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا» النساء / 82.
ومن عظمة هذا الكتاب المعجز، وبيانه الساحر أن الله تعالى لم يحجر علينا تلاوته وتدبر معانيه، بل شجعنا على ذلك، ويسر لنا السبيل إلى تدبره.
لقد لفت الحق سبحانه وتعالى إلى أن المشاغبة على القرآن الكريم لن تتوقف، والهجوم عليه بما يسيء لن تنتهي، وقول الحق سبحانه: «..وإنه لكتاب عزيز (41) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. (42)» يشير أو هذا ما أفهمه، إلى الأمم المعاصرة له، وأن في قوله تعالى: «ولا من خلفه» يقصد بها الأمم التي سوف تأتي في المستقبل، أما قوله تعالى: «وإنه لكتاب عزيز» ففيه بشارة إلى أنه لن يغلب، ولن تنال الأمم منه سواء في عصر نزوله أو في العصور التي سوف تتوالى من بعده، وهذا مقتضى حفظ الله تعالى له سبحانه وتعالى.


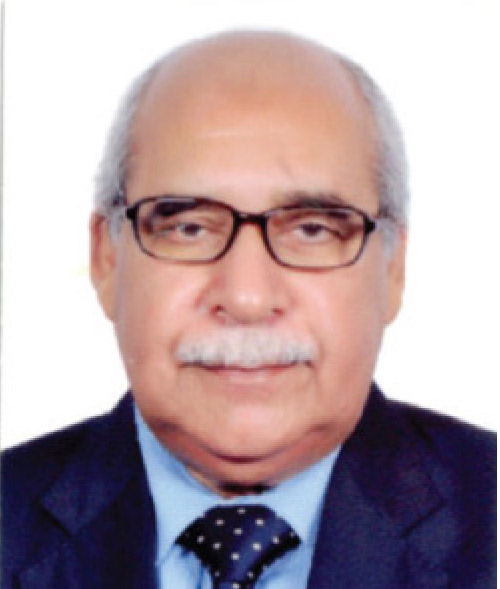






هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك